بيادر المِلح وقِصة بُذور زُهور القُرنفُل

الدكتور فاروق القاسم - 28- 12 - 2021
عام 1986 كان عاماً قحاً، حيث الجفاف والمحل، وقلة الأمطار، عام ٌ وقفنا فيه نحن أبناء الفلاحين طلبة الجامعات حائرين في صيف هذا العام سألت فيه الوالد العظيم الأسطورة أبا فيصل عن كيفيّة تأمين مصاريف الدراسة الجامعية للسنة المُقبلة في وقت ٍ لا موسم َ للحصاد ِ فيه ولا بيادر ولا أعمال حرة ولا حكومية لاسيما وأنه عام ُ الحصار على سوريا، بعد حادثة ما يُعرف بمطار لندن بقصة ِ نزار هنداوي الأردني الجنسية الذي اتُهم بالإرهاب أنداك في محاولة تفجير طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية في مطار هيثرو في لندن، (وذلك لحساب سوريا) لسنا بصدد ما إذا كان ذلك الاتهام لدمشق زوراً وبُهتانا أو حقيقة، فالسياسة ُبالنهاية نجاسة دفعت ثمنها الشعوب المقهورة.
المهم نظرتُ الى والدي بعد سؤاله، فوجدتُ في عينيه كل حزن وشفقة الأرض كان في سكوته الكثير الكثير إذ منذ إدراكي لهذه الدنيا أصبح يعتمد ُعليَّ ويُشاورني بكل شيء سيما وأنني نجلهُ الثاني في ترتيب الأُسرة وكنت أدرك بأن المسؤوليات كبيرة على عاتقي وعليِّ أن اتحمّل المسؤولية، بعد أن توجّه أخي الكبير العظيم الأصيل قبل عدة سنوات الى بريطانيا لدراسة الدكتوراه، وعندما نقول: "لا يتحرّك ساكن ولا يسكن مُتحرك إلا بمشيئة الله فإن تِلك هي حقيقة مُطلقة.

المُهم ألتقيتُ في الضيعة صُدفةً بإبن عم لي، لم أرهُ منذ زمن بعيد، سألتهُ عن أحوالهِ، فقال لي: إنهُ كان يعمل في ليبيا منذ عدة سنوات، وإنهُ بِصدد التوجُّه الى عمّان الأردن بعد عِدة أيام، حيثُ هناك فُرص للعمل متوفرة، قلت ُ في نفسي: يا الله،، معناها يجب أن أذهب الى الأردن في أسرع وقت، سيما وأن الصيف في بدايتهِ، كي أبحث عن عمل هُناك لِمُدة شهرين على الأقل قبل بِدء الفصل الدِراسي المُقبل، ثم تركتُ ابن عمي وحال نفسي يقول: إذا عزمتم فتوكلوا على الله، شاورتُ الأهل وطلبتُ بعدها من والدتي العظيمة الجليلة أم فيصل أن تُحضّر لي شنطة، خاصة ًوأنها المرّة الأولى لي التي أُغادِرُ فيها خارج بلدي سوريّا، هذهِ التوطئة في السرد ضرورية، وهي كما تعلمنا في كِتابة السيناريو القصصي، ما يُعرف ُ ب " الخطف خلفا " Flash Back “ المُهم أعطتني والدتي فِراشاً إسفنجيا رقيقاً، مع مِخدة، وضعتُها داخله، ولففتهُ بخيط { مصّيصّ } حسب لهجتنا في السويداء في جبل العرب جنوب سوريا، مع شنطتي التي آخذها معي الى الجامعة، وفيها ما يحتاجهُ الفرد بحياته اليومية.
في صباح اليوم التالي 27/6/1986 توجّهت ُ من قريتي الثعلة، بما أعتبره ُ مُنعطفاً تاريخيّاً في حياتي، توجهت الى مركز المدينة في السويداء، حيث ُمركز تجمُّع التكسات التي تنقل الرُكاب من المدينة والى عمّان، وبالعكس، وجدتُ سيارة، قال سائقُها بإنه يحتاج الى راكبين إضافيين كي ننطلق، بعد حوالي نصف ساعة، اكتمل النِصاب، وتوكلنا على الله، جلستُ في المقعد الخلفي جانب الشبّاك، وفي دماغي ألف ألف سؤال، اهمُّها خوفي من الفشل والعودة خالي الوفاض، وهذهِ في ثقافتنا لا تنساها الناس، فما زالوا في منطقتنا يقولون: " مثل سفرة حامد "كنت قبل السفر قد اشتريت ُ من أحد محال المدينة أربعة أزواج من الأحذية، لبيعها هُناك، إذ قالوا لي إن الأحذية في الأردن غالية الثمن، عندما وصلنا مدينة درعا، غرباً، كان الصمت ُ في السيارة ثقيلاً الى درجة أنك تستطيع ُ حزَّه بالسكين، وجوه الركاب كلّها كئيبة، وكل واحد له ُ قصته ووجهتُه، كنت الطالب الجامعي الوحيد بينهم، والباقون شباب، ربما أصغر مني سناً، لكن وجوههم شاحبة، خدودهم ضعيفة، تقرأ فيها قصّة أهل الكهف، قبل وصولنا مدينة الرمثا بدقائق كسر َ السائق ُ حاجز الصمت بأن فتح المذياع، على إذاعة دمشق، على أُغنية سمِعتُها لِأول مرة بحياتي، للمطربة لا أعرف إسمها أنذاك، تقول ُ كلماتُها: " سامحني يا بابا، جاني الحُب ورافقتو قلبي يا بابا سلمتو، سا محني يا باباً لا أدري،، كيف انهمرت عينايا بالدمع، مركز بوابة الرمثا الأردنية، وأصبحنا خارج الحدود السورية، لا أدري ماهيّة الحركة التي قام بها السائق، إذ أخرج من تحت كُرسيّه كروز دخان مارلبورو، وقدّمه للشرطي الأردني، فما كان من الأخير إلا أن وبّخه بألفاظ سيئة جداً، ورفض أخذ الكروز، وأراد أن يحوّله الى محضر تحقيق، بِتُهمة الرشوة والفساد، بقينا نحن في السيارة، وقلتُ في نفسي: يا الله، واضحة السفرة من أولها، بعد اكثر من ساعة عاد السائق ووجهه مُكفهِر، سار فينا بعدها حوالي 500 متر، وهناك نزلنا جميعا أمام مركز الأمن والتفتيش.

كان دوري الثالث في المركز، دخلت ُ وما زال وجه ُ ذاك المُحقق مطبوعاً في مُخيلتي، كيف كانت عيناه تتحركان مثل عيني النسر، مُخيفة، إذ تعرف الدول من تضع في المنافذ من أشخاص، فعلاً، بدأ التحقيق معي، وأنا القادم من أجل لُقمة حلال صادقة، لماذا أتيت الى هنا، ماذا تعمل في بلدك، كم المدة التي ستقضيها هنا، هل تعرف أحداً هنا؟ الخلخ الخ من أسئلة " زاد اهتمامه أكثر عندما عرف أنني طالب جامعة، أدب إنكليزي " لِسوء حظي أنه عندما بدأ بتفتيش شنطتي، التي أستخدمها عادةً لنقل أشيائي بين دمشق والقرية، وجد نُسخة قديمة من صحيفة" الثورة" السورية، وضعتها منذ أكثر من سنتين، لحماية أرض الشنطة، دون أي سبب، و[ يا حُرّة مع مين علقتي ] بدأ يصرُخ في وجهي، من أنت؟؟ ولماذا أتيت، وما هذا؟؟ جايب الثورة معك ع بلدنا، كُنت في أعماق نفسي مُدركاً أنه يُمثِّل، وهو يعلم بِأنها نُسخة قديمة، ولا تُشيرُ أبداً بِأن وجهَ صاحبِها إرهابي أو ينوي شرّاً، لا قدّر الله، والله كانت مسرحية هزّلية بامتياز، لا تستحق ُّالوقوف َعندها لِوهلة، استمرَّ في تفتيش الشنطة، نكتها جيباً جيباً، وكما يُقال: الله ما بيبلي ليعين جلَّ شأنه.
فخِلال البحث فيها وجدَ ظرفين مِن بذور ورد القُرنفُل، وهو الورد الذي أعشقهُ جداً مِنذُ طفولتي، كُنت قد اشتريتهُ مِن دِمشق مِن زمان، كي أبذرهُ في حاكورة بيتنا بالضعية، ونسيتهُ رُبما كانت حِكمة مِن الله لِهذهِ اللحظة، وهي حكمة بدون شك، قال لي: ما هذا، قُلتُ لهُ بذور ورد القُرنفُل، قال لي لِماذا جلبتها معك: ؟؟ قلتُ لهُ لِأزرعها في الأردن، عِندها نظرَ إليَّ بِعُمق مع تنهيدة عميقة، ومسكَ جواز سفري وختمهُ، ثم أعطاني إِياه، بعد أن شعرتُ بِأن سوائِل جِسمي قد جفّتْ، وبعد أن رمى الصحيفة في سلة المُهملات قال لي، أهلاً وسهلاً بِك في الأردن!!!

شكرتُهُ والدمعة في عيني، ربت َعلى كتفي، وقال: سامِحنا عمي، الله ييسّر أمرك، رُبما تكون هذهِ أشرف وأصدق كلمة قيلت فِعلاً مِن قِبل عُنصر مُخابرات عربي بِحق مُواطِن عربي مقهور!!!! كنتُ أنا الوحيد، سُبحان الله الذي أخّر السفّرة بِهذهِ السيارة، فزمُلائي في الرِحلة لم يستغرق التحقيق معهُم بِضع دقائِق، دخلنا الأردُن، نحوَ مدينة الزرقا، حيثُ العُنوان الذي أحمله، وثُلّة ٌهُناك مِن أبناء قريتي المساكين، في "حي معصوم" الذي تكتنِفهُ مِن جِهة الغرب كلِمة {العجّان} بِلهجة أهل المدينة، المقبرة بِثقافتِنا، دخلتُ الى حوش، فيه إثنا عشر شخصاً من قريتي ومِن مدينتي السويداء، لا يُمكن وصف الموقف وحال الشباب المساكين، كُلَّ واحِد ينام وحذاؤهُ خلف رأسهِ، الدُنيّا صيف، والجو حار جداً، والكُل ينام في باحة الحوش، وفي زاويته جورة فنيّة لمياه المجاري، يأتي الصهريج كُل ثلاثة أيام لِنضُخ ما بِداخلها، نمتُ الليلة الأولى، ووالله والله والله، كُنت على يقين بِأنهُ سيأتي يوم لِأسرُد في مُذكراتي تِلك اللحظات، فكّرتُ بِأزواج الأحذية الأربعة التي معي في الشنطة، استيقظتُ باكِراً دون أن أُعلِم أولاد بلدي بِما معي، سألتُ مواطنين صباحاً في الطريق، عن سوق لِلتبضُّع، دلّوني على شارع يُدعى، بشارع "السعادة" وفعلاً إنه اسم ع مُسمّى، ذهبتُ إليه ومعي الأحذية، دخلتُ متجراً كبيراً فارِهاً، وتعرّفتُ على شاب من آل "عيشة" يا لهُ من شاب في قمّة اللباقة والكرم، عرّفتهُ على نفسي، ووالله شعرتُ بِأن لي موعِداً معهُ، هذهِ الإِشارات عرفتُها في ما بعد بعدما قرأتُ "ُرواية الخيميائي"، لِلكاتب البرازيلي العالمي، باولو كويلو، قام بِضيافتي بِشكل غريب، واعترف لي بِأن والِدهُ مسجون في سوريا مِنذُ عِدة سنوات، وعندما ذكر لي العام، علِمتُ أنهُ رُبما تمّ سجنهُ بِتُهمة الانتماء لجماعة "الإخوان المُسلمين".

المُهم، حدثتهُ عن الأحذية، فعمِدَ إلى شِرائِها كُلها مِني، وبِأسعار خيالية، وأكرمني كثيراً، وطلب الغداء الى المتجر، تذكرتُ دُعاء أمي الدائِم لنا، وهي تخبز على التنور، {يا أمي إن شاء الله بتكون رجلكم بِالركاب وصيتكُم بِالبلاد، ويشرّد لكُم ولاد الحلال، ويردّ عنكُم شرّ ولاد الحرام} ما حصلتُ عليه مِن ثمن الأحذية رِبحاً لا يقِل عن عشرة أيام عمل، عدتُ الى الحوش لأرى الوجوه المُكفهرّة الحائِرة، لم أقُل لهُم ما حصل معي، عملاً بِمقولة رسولنا الكريم، واستعينوا على قضاءِ حوائِجكُم بِالسِرّ والكِتمان، لا أعلم ُ فِعلاً في ما إذا كان الله قد حباني مِنذُ تِلك الأيام حِسّاً صحفياً، فقد لاحظتُ يافطات وصوراً في ضفاف طُرقات الأردن آنذاك للمرحوم الراحل صدام حسين بالآلاف، إذ هُناك صورة واحِدة لِلملك الراحل حُسين بن طلال رحمة ُالله عليه، وعشرات للمرحوم صدام حسين، حيثُ كانت وقتها الحرب الإيرانية العراقية، وكان الأردُن يقفُ بِكُل طاقاتهِ الى جانب العراق، وكنتُ أُشاهِدُ الشاحِنات الكبيرة المقطورة بالمئات، المُحمّلة بِما لذَّ وطاب، تتجه على الأوتستراد السريع شرقاً نحو العِراق، ورُغم كُل هذا الخير الذي يتجه نحو بغداد، فإِنني صُعِقتُ عِندما دخلتُ السوبر ماركات هُناك، وهي مُمتلِئة ٌرفوفُها عن آخرها بِكُل أنواع الخيرات مِن البِضاعة، وهي التي فُقدت تماماً مِن سوريا بسبب الحصار، المُعلبات علب المحارم الورقية، الشاي والسكر، وكُل أنواع الزيوت والسمنة، أجمل أنواع الكاسات والفناجين الفرنسية الأصلية، وكُل أنواع ِالصابون ذي الرائِحة الطيبة، اللحوم والبيض والدجاج، والله والله بِصدق كانت جنة، ذهبتُ ذات مساء، وكان دوري في تحضير العشاء لِلشباب في الحوش، ذهبتُ كي أشتري بعض الاشياء، دخلتُ متجراً في بلدة "الأزرق الشمالي"، والشيشان التي وصلتها للعمل فيها عند الأهالي بموسم [بيادر الملح] والتي يخترِقَها الطريق السريع نحو العِراق شرقاً، وجدتُ رجُلا كهلاً يجلس أمام دُكانهُ، يعتمِر الحطة والعقال، ويرتدي سِروالاً أبيضَ، بيدهِ مِسبحة وأمامهُ طاولة صغيرة، عليها صينينة مِن الألمنيوم، وعدد من الكاسات، دعاني معهُ لِاحتِساء كوب مِن الشاي، يا إلهي كُم سُرِرتُ بِذلِك، وبدأ يُحدثني عن الحياة ومشاقها، ويشكو لي من قِلّة المواد الاستهلاكية، وضُعف جودتها، فكُل شيء أصلي ونخب أول يذهب الى العِراق، وهو يرى الشاحِنات الكبيرة أمام متجرهُ تتجه شرقاً، يا إلهي كم ضحِكتُ في نفسي وهو يتحدث، ولا يعلم أنهُ بِمتاجر قريتي كُلها آنذاك لا توجد عُلبة سردين واحِدة ولا عُلبة محارم واحدة ولا كيلو موز واحد.
كُلّ هذا السرد قصصتهُ كي أصِل إلى ماذا حصل معي في بيادر الملح، إلى الحوش بِمدينة الزرقا إِذ بقيتُ حوالي خمسة أيام أبحثُ عن عمل دون جدوى، اللّهُم من يوم عملت فيه ب صب الباطون ونقل الطوب، البلوك الى سطح احد المنازل، قال لي الشباب إن هُناك شُغلاً، شرقاً بِبلدة الأزرق الشمالي، في حقول الملح لِكنهُ عمل شاق جداً، والشمس حارِقة، لكِن بِالنسبة لي وقتي ضيّق وسأعمل حتى ولو بِمناجِم الفحم، وصلتُ الأزرق الشمالي، كم هذا العالم صغير فِعلاً، وفور وصولي، علِمتُ بأن سُكان تِلك المنطِقة كُلهم أصلاً مِن سوريا، وتحديداً من مدينتي السويداء، جاؤوا إلى الأُردُن مع المرحوم شيخ الثُّوار سُلطان باشا الأطرش، واستقروا هُناك، بعد أن تعرّض الجبل جنوب سوريا للاضطهاد خلال العهد العثماني، وبعدهُ الفرنسي، تعرّفتُ هُناك على شيخ يُدعى أبا علي ثاني قماش، في السبعينات مِن عُمره آنذاك، عِندما عرفّتهُ على نفسي، سألني فوراً، هل أنت مِن أقارِب الشيخ "بو محمد كامل القاسم" قلتُ: نعم إِنهُ جدي وجارنا مُباشرةً مِن الجنوب، قال لي: يا إلهي، هذا الرجُل خدمت ُوإياه ردحاً طويلاً مِن الزمن مع الإنكليز في فلسطين، وجدي هذا كان طولُه 225 سم، كانَ عِملاقاً ورجُلاً عزّ نظيرُه بِالقوة البدنية، رحمة ُ الله عليه.

المُهم، قال لي العم ثاني قماش، واعتقد حتماً أنه أصبح بِديار الحق، بعد هذا العُمر، رحمة الله عليه، قال لي: يا عمي أنا عندي بيادر ملح، وفيها شباب مِن عِندكُم في السويداء، موجودون الآن فيها، تبعُد حوالي ثلاثين كيلومتراً إلى الشرق، فهل تتحمّل العمل فيها، لأنها شاقة؟ قلتُ إن شاء الله، أخذني بسيارته ووضع الطعام والماء لِيأخُذهُم إلى العُمال هُناك، صِدقاً صِدقاً صدقاً، شعور لا يوصف، وصلنا الى صحراء، لا تُشبه أُخرى في العالم، أرض ملحيّة،، مليئة بِالشقوق الكبيرة، وأنت تمشي فوقها، تشعُر بِأنك تدوس على زُجاج مُحطّم، عرّفني على شابين مِن مدينتي السويداء، مِن آل نصر والاخر من آل رِضا، وتركَ لهُما مُهمة إِرشادي إلى ماذا يتوجب عليَّ فعلهُ، لا توجد بيوت ولا خيام، فقط كوخ صغير، سقفهُ مِن الخيش، لهُ فتحة مِن الشمال وأخرى مِن الجنوب، وعندما غابت الشمس صارت صحراء مُوحِشة جِداً جِداً، تحُدّها السعودية جنوباً، وسوريا شمالاً والعِراق شرقاً والأُردن مِن الغرب، نام الشباب قبلي، كونهُما مُرهقين، نظرتُ الى السماء الصافية وفيها مليارات النجوم والمجرات لم أر هذا المنظر مِن قبل شعرتُها قريبة جداً مني وأكثر مِن المُعتاد الشُهب تتساقط وتختفي دخلتُ لِلنوم ولِسان حالي يقول: يا إلهي ما الذي جاءَ بي إلى هُنا ؟؟ بعد أقل مِن نِصف ساعة وأنا نائِم وكيف لي أن أنام مِلئ جفوني؟
تذكرتُ قول المرحوم الشاعر شبلي الأطرش عِندما كان مسجوناً في الأستانة بِتُركيا "بعضُ الليالي تنامُ نومةً هنيّةً، وبعضُ الليالي تنامُ ع الشنديب" والشنديب هو مِن أسوأ أنواع الشوك في الصحراء. والمُهم بعد حوالي نِصف ساعة مرَّ فوق وجهي الشابين بِسُرعة هائلة مخلوق لم أرهُ مِن قبل بتاتاً دخل من الطاقة الشمالية وهرب من نظيرتها الجنوبية، أيقظتُ أحد الشباب وسألتهُ عن شيء غريب دخل الكوخ واختفى، قال لي مُبتسِماً: لا تقلق لا تقلق هذا اسمهُ جربوع، صحراوي هو الوحيد الذي يعيشُ هُنا وهو نوع من السحالي يأكلهُ سُكان المنطقة إذا اصطادوه، فطمأنني وقال: نم ولا تقلق المنطِقة أمان جداً ولا توجد وحوش التفاصيل كثيرة جداً ومُشوّقة أمضيتُ مع الشابين مدة 25 يوماً، تعلمتُ فيها كيف ننضح المياه الملحية من عمق واحد متر تقريباً مِن خِلال موتور يعمل بِوقود البنزين ويصبُ في بيدر طولهُ بين الثلاثين والخمسين متراً بِعرض عشرين كُنا نجمعُ التُراب بِشكل سواتر بِارتِفاع حوالي نصف متر ونفرُشها برولات البلاستيك السميك الذي يحفظ المياه ونترُكها تحت أشعة الشمس الحارقة إلى أن تُصبِح مِثل طبقة الثلج بعد تبخُر المياه، ونقومُ بتحريكها بِالمجارف ونعودُ ونملأ المنقع (البيدر) مِن جديد بالمياه وهكذا، حتى يُصبِح الملح بسماكة حوالي أربعين سم، بعد أن تكون المياه قد جفّت نهائياً، ويُصبح الملح بِشكل درابي وكباتيل بعدها نقوم نحنُ الثلاثة بِجر مِدحلة كبيرة وثقيلة فوق تِلك الكُتل شمالاً وجنوباً حتى يُصبح الملح مهروسا ًناعِماً وبعدها نُخطر صاحب البيدر بأن الملح قد أصبح جاهزاً لِنقلِهِ بِالشاحِنات إلى المصنع على طريق عمّان غرباً.
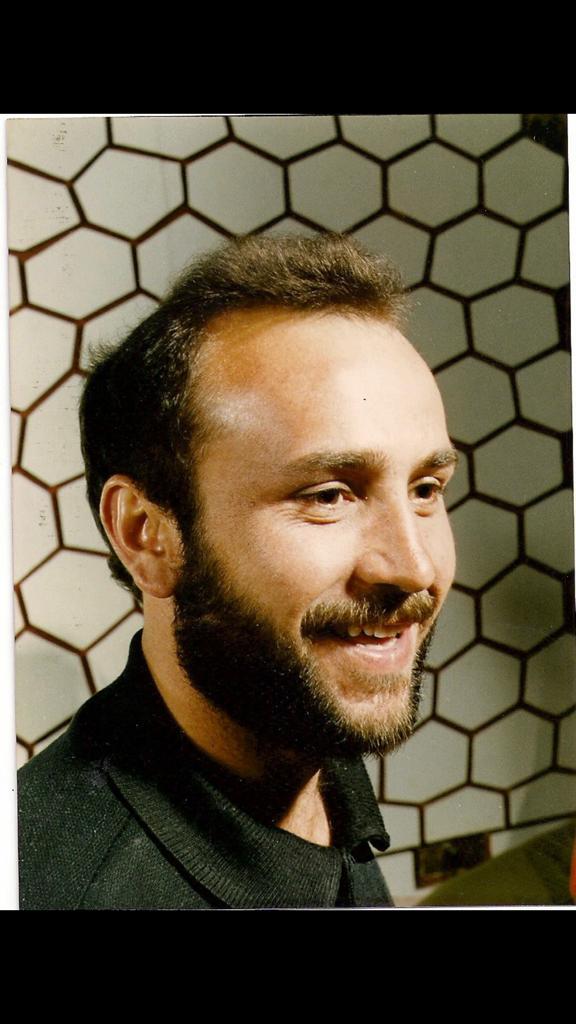
كُلّ تِلك المُدة عِند النوم ليلاً كانت فلزات الملح تُبرقُ في عدستي عيني اللون الأبيض وانعكاسات الملح تُبرق كالأشعة. جاءتَ شاحِنات النقل الكبيرة، ومعها عُمال أشاوِس، مُحترِفون، كانت مُهمتي تعبِئة المِلح بِالكريك بأكياس كبيرة كُنا نستخدِمها على بيادرنا في القرية لِتعبِئة القمح والحُمص في أكياس الخيش ذات الخط الأحمر، والله لا أُبالِغ إذا قُلت إِن الشوال الواحِد مِنها يزِن حوالي 160 كيلو غراماً مِن المِلح، والملح ثقيل جداً جداً، بدأ العُمال المصريون والسودانيون بِحمل الشوالات على ظهورهم لتفريغها على متن الشاحِنات، عن طريق لوح بُندي خشب، وخِلال عمليات التشجيع لِلشباب، طلب مني ثلاثة ُ مصريين كنوع من التحدي أن أحمِل كيساً مِنها إلى القاطِرة. ونعم عِندما تأتي ساعة النحس رُبما تقضي على حياتك لِلأسف قبِلتُ التحدي احتراما لِرجولتي وكوني قروياً فلاحاً وابن كار...
إِنهُ الجُهل بعينهِ، حمِلتُ الشوال والله لا أُبالِغ إذا قُلت أن وزنهُ أكثر مِن 160 كيلو فأنا عادةً كُنتُ أحمِل شوالات القمح والحُمص بِهذا الحجم، ولكن ليس الملح😞، بدأتُ الصعود على اللوح الخشبي لِتفريغهِ على متن الشاحنة، الكُل يُنظر اليّ، أبت نفسي وكبريائي ورجولتي أن أرمي الكيس، أوصلتهُ، وأفرغتهُ، لكني أدركتُ فجأةً حجم الخطر والجهل الذي ارتكبتهُ بِحق نفسي، نزلتُ وتوجهتُ بعيداً عن العُمال وأصبح وجهي أصفرَ وبدأ الغثيان في معدتي، والله لا أُبالِغ إذا قُلت بِأنني شعرتُ بِأني سأبصُق كُليتي مِن شِدة الألم، شاهدتُ الدم يخرُج مِن فمي، التفاصيل كثيرة، لكن تعلمتُ درساً ثميناً مدى الحياة ونقلتهُ في ما بعد لِكُل من أُحبهُ، هو:" فكِّر قبل أن تعمل".
في هذا السياق علِمَ أقارب ٌلي وأهل شُرفاء مِن الأزرق الشمالي بِما حصلَ لي، فهبّوا كالسباع لِمُساعدتي، دار العم المرحوم "أبو فهد حمد والي" ونِعمَ الدار ونعم الرجال، لم يكونوا قد عرفوا بوجودي هناك وعندما عرِفوا بِوجودي هُناك، تركتُ العمل في الملح، وأوجدوا لي عملاً بسيطاً مُدة الأسبوعين الاخيرين قبل بِدء العام الدراسي وأكرموني جِداً خاصةً الأخوين فهد وجديع لم ولن أنسى معروفهما ومعروف والدهما ما حُييت تركتُ تلك الدار الأصيلة وآخر جُملة سمِعتُها مِن العم المرحوم "أبو فهد حمد" يا عمي سلِّم ع الأهل واستر ما شفت مِنّا وهذهِ جُملة يقولها أهل ُالجبل إذ يقدمون أرواحهم للضيف وبعدها يطلبون مِنهُ عدمَ المُؤآخذة في حال حصل مِن جانِبهُم أي تقصير يا الله يا الله، أين نحنُ اليوم مِن تِلك القيم والمروءة ؟؟!! ألف مليار حمد وشُكر لِله عزَّ وجلّ على تِلك التجرُبة، عدتُ لِأهلي حينها مرفوع الجبين، وكانت محطة أساس في حياتي، تعلمتُ مِنها الكثير!!
خِتاماً ... أستذكِر قول عمي المرحوم أبي وطن، الشاعِر الكبير سميح القاسم ها أنا أسرجت ُ كلَّ متاعبي دمّي على كفّي تعالوا فاشربوا.



